أخرى
كُتب الرحالة والجغرافيين وأهميتها في كتابة التاريخ
كُتب الرحالة والجغرافيين وأهميتها في كتابة التاريخ
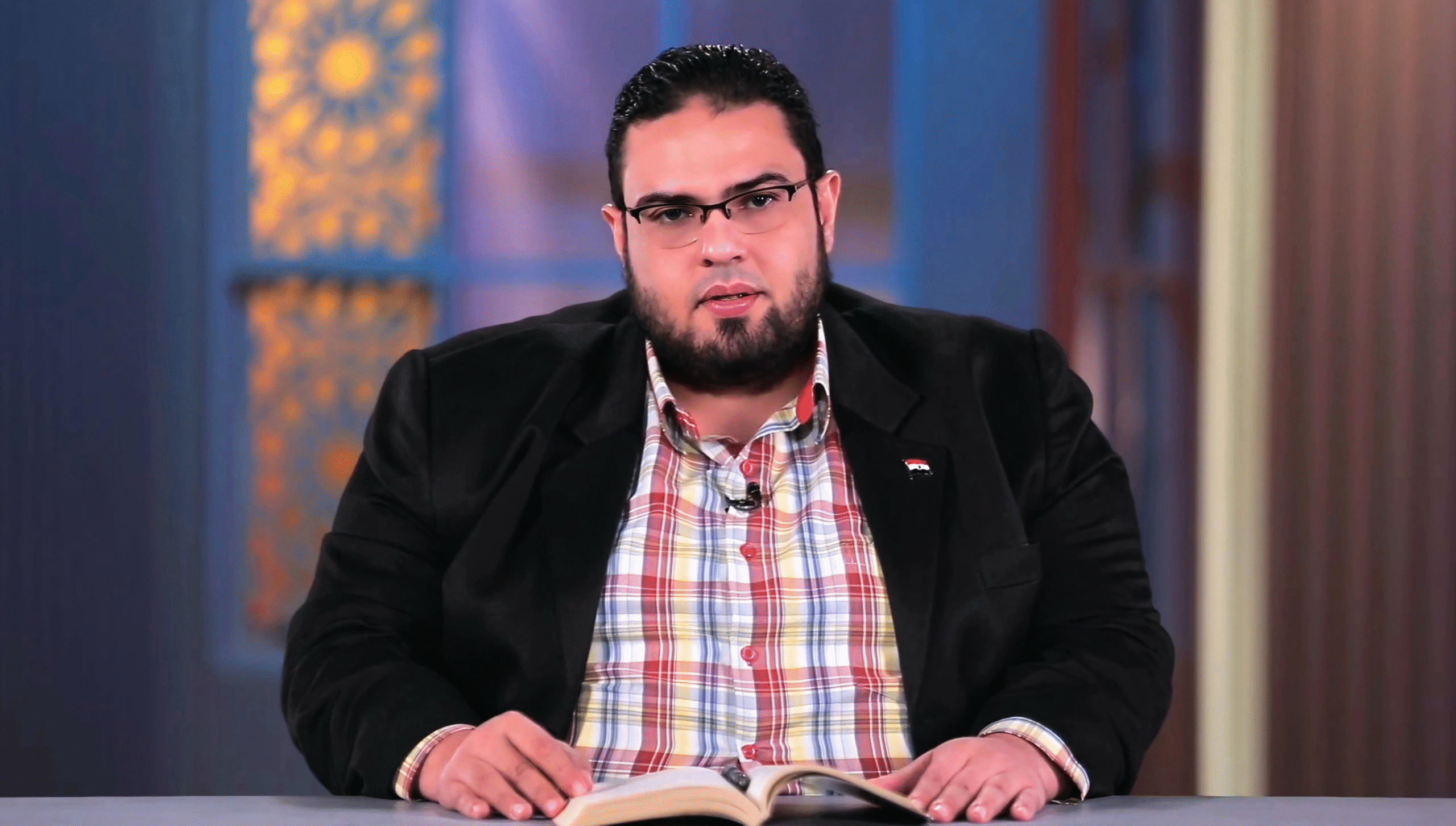
حفل التاريخ الإسلامي برحّالين عظام أثّروا الحركة الفكرية والثقافية وكان لهم دور بارز في إمدادنا بمعلومات ثرية عن العالم الإسلامي وغير الإسلامي في ذلك الوقت.
فاليعقوبي قام برحلات إلى أرمينية وإيران والهند ومصر وبلاد المغرب وألف لنا كتاب «البلدان»، ووضع الإصطخري كتابه «مسالك الممالك»، وللمسعودي كتابه الشهير «مروج الذهب ومعادن الجوهر»، ولشمس الدين المقدسي «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»، وابن حوقل ألف في القرن الرابع الهجري كتابه «المسالك والممالك»، والبِيروني الذي عاش في القرن الخامس الهجري ألف كتاب «الآثار الباقية عن القرون الخالية» ، وكتاب «تحقيق ما للهند من مقولة مرذولة في العقل أو معقولة»، والبكري الذي عاش الربع الأخير من القرن الخامس له كتاب «المُغرِب في ذكر أفريقية والمغرب»، ومرجعه الشهير «معجم ما استعجم»، وفي القرن السادس الهجري ألف الإدريسي «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»، وفي القرن السابع كتب ابن جبير رحلته المشهورة، وكتب ياقوت الحموي «معجم البلدان»، وفي القرن الثامن يطلع علينا الرحالة الذائع الصيت ابن بطوطة ويكتب رحلته التي نسبت لاسمه «رحلة ابن بطوطة»، واسمها الأصلي «تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار».
وهذه المصادر تشكل أهمية كبيرة لدى الباحث التاريخي، فسيجد فيها معلومات مهمة عن هذه البلاد وعاداتها وسياستها، فعلى سبيل المثال: فإن تاريخ نشوء الدولة العثمانية سُجل بعد النشأة بكثير، والمعلومات التاريخية عن هذه الحقبة قليلة للغاية، ومع ذلك نجد في «رحلة ابن بطوطة» معلومات مهمة، فقد زارها في عهد أورخان بن عثمان، ثاني أمراء الدولة العثمانية، وفي حين أن المؤرخين العثمانيين يذكرون أن عثمان لم يكن لقبه حال حياته إلا (بك) أي: أمير، ولم يلقب بسلطان أو خان إلا بعد وفاته([1])، وهكذا كان لقب ابنه أورخان، ومن بعده مراد الأول، ولم يظهر لقب السلطان إلا بعد هؤلاء الثلاثة، فإن ابن بطوطة في رحلته ذكر أورخان وأباه بالسلطان، ووصفه بأنه أكبر ملوك التركمان وأكثرهم مالًا وبلادًا وعسكرًا، له من الحصون ما يقارب مائة حصن([2]). وهذا يدل على أنهم وإن لم يلقبوا بذلك فلا شك أن مهامهم هي مهام السلطان، وربما لم يتلقبوا بذلك تواضعًا أو تدرجًا في المناصب ما دعا إلى إطلاق ابن بطوطة اللقب عليهم.
كما أنه رأى قبر عثمان في بورصة، التي اتخذها ابنه أورخان عاصمةً له([3])، وقبره كائن إلى اليوم في حي «طوبخانه».
كما أنه رأى نظام الأخية وهي روابط تربط كل طائفة من الحرفيين، بمنزلة النقابات في زماننا المعاصر، وكان لكل طائفة رئيس، ولها نظام وهيئة، وقوانين وأعراف، كما كان ينضم لكل طائفة أحد مشايخ الصوفية في المنطقة ليؤسسوا جميعًا رابطة تجمع روابط الأخوة الإسلامية بين أفراد كل حرفة، وأعجب بهم ابن بطوطة وتحدث عنهم ونقل إلينا أفعالهم في رحلته([4]).
ولا يخفى على الباحثين أهمية هذه المعلومات الصغيرة في تاريخٍ ناشئ كثير منه غير موثق نلمح فيه النسج الشعبي الأسطوري المضطرب، بخلاف الاتهامات التي توجه من حين لآخر لهم. فهذه شهادة معاصر رأى بنفسه ولم يسمع من غيره.
وعلى الباحث أو المؤرخ أن يدرس بعناية الرحلة التي تغطي العصر الذي يكتب فيه أو القطر الذي يؤرخ عنه، بل عليه أن يداوم على مطالعة مثل هذه الكتب ليصل بسهولة إلى مظانه التي يبحث عنها.
وهناك الكثير من الرحالة الأجانب الذين جابوا منطقتنا العربية من القرن السابع عشر إلى أوائل العشرينيات، والواقع أنه لا يمكننا تفريغ مضمون رحلات هؤلاء الأجانب من مضمونها السياسي والاستعماري، فإذا كان سلفنا المسلم لا يقصد من رحلته إلا العلم خالصًا لوجه الله، فإن رحالة العصر الحديث ومكتشفيه من الأوروبيين –وإن كانوا قد أدوا للعلم الجغرافي والتاريخي فائدة غير منكورة– لهم أغراضهم السياسية والاستعمارية، وتبعيتهم لجمعيات لا تُخفي دورها الاستعماري قد شوهت جهدهم العلمي، وكان لِزامًا على الباحث أن يتحرز فيما ينقله عنهم في بعض الأحيان، خاصة في مجال تفسيرهم للأحداث ووصفهم للمعتقدات، وعلى الرغم من علمهم الذي لا ينكر فقد يجهلون العادات والتقاليد المحلية فيفسرونها تفسيرًا خاطئًا، وقد يكون هذا التفسير مغرضًا أيضًا. مثال ذلك:
الرحالة الأوروبي الذي جاب غرب أفريقيا «منجو بارك»، وكانت إحدى رحلاته سنة 1795م تحت عنوان «ملك الوولي» (The King of wooli) .
فهو يقول «كانت المدينة (Medina) هي عاصمة مملكة وولي (Wooli) والمدينة كلمة عربية تعني بالإنجليزية city ولم يكن الاسم شائعًا بين الزنوج، ويحتمل أن يكون المسلمون هم الذين أدخلوه».
لاحظ هنا إصرار «منجو» على الفصل بين الزنوج والمسلمين، إنه يتحدث عنهم كعنصرين مختلفين، وكأنما لا زنوج مسلمون، ولا مسلمون زنوج، ثم لاحظ قوله: إن الاسم غير شائع بين الزنوج ، كيف ذلك مع أنها عاصمة مملكة؟ أما كون اسم (المدينة) من أصل عربي وأنه أتى في ركاب المسلمين، فهذا أمر لا يدعو للظن أو الشك، ثم يستمر مانجو بارك، قائلًا:
«لقد حططت رحالي في المدينة، وهي واسعة، ويحيط بها سور من الطين مرتفع، وذهبت بعد الظهيرة لتقديم الاحترام للسلطة (الملك)، ولأسأله السماح لي بالمرور عبر بلاده إلى بوندو (Bondou)، ولقد ألقيت التحية على الملك باحترام وأخبرته عن أسباب زيارتي، وقد أجابني الملك قائلًا: أنا لا أعطيك فقط حق المرور بل سأقدم لك بركاتي وتمنياتي بالسلامة، وعندئذ شرع واحد من المرافقين لي في الغناء أو بالأحرى في الزئير، فقد كان صوته قويًّا غير جميل، وقد كانت أغنيته بالكلمات العربية، وعند كل مقطع من الأغنية كان الملك نفسه وكل المحيطين به يضربون بأيديهم على جباههم، ويرددون بخضوع وتأثر شديد: آمين.. آمين».
من الواضح أن الرجل يدعو الله، ومن الواضح أن الملك ومَن حوله يؤمنون على الدعاء، ومن الواضح أن الكلمات العربية خاصة كلمات الدعاء مفهومة من الملك، ومن الواضح أن الملك مسلم، وبالرغم من كل هذا فإن منجو بارك يعلق قائلًا: «إن الملك لم يكن بالتأكيد مسلمًا»، ولم يذكر لنا منجو بارك مصدر تأكيده هذا، ويستمر قائلًا: «وربما فعل الملك ذلك لأن نفسه خيِّرة وطيبة»([5])!
تعليل غريب، والغرض واضح، لقد أحال منجو بارك تمنياته بألا تكون هذه المناطق على الإسلام، إلى تقرير خالف به الواقع.
هذا مجرد مَثل يجعل الباحث يُخضع كتب الرحالة الأوروبيين للنقد أو التقويم قبل الأخذ عنها.
أحمد المنزلاوي – عضو اتحاد كتاب مصر
([1]) «تاريخ الدولة العثمانية» يلماز أوزتونا (ص91).
([2]) رحلة ابن بطوطة (2/ 197) أكاديمية المملكة المغربية- الرباط 1417 هـ.
([3]) رحلة ابن بطوطة (2/ 198).
([4]) رحلة ابن بطوطة (2/ 163)، وانظر: كتابنا «عثمان بن أرطغرل» ص 163-165، دار مبدعون للنشر والتوزيع، 1441هـ=2020م.
([5]) Park, Mungo: Travels in the interior districts of Africa, 5th ed London,1807. PP20-25.
نقلًا عن: المدخل إلى علم التاريخ، د. عبد الرحمن الشيخ، ص104، 105.


