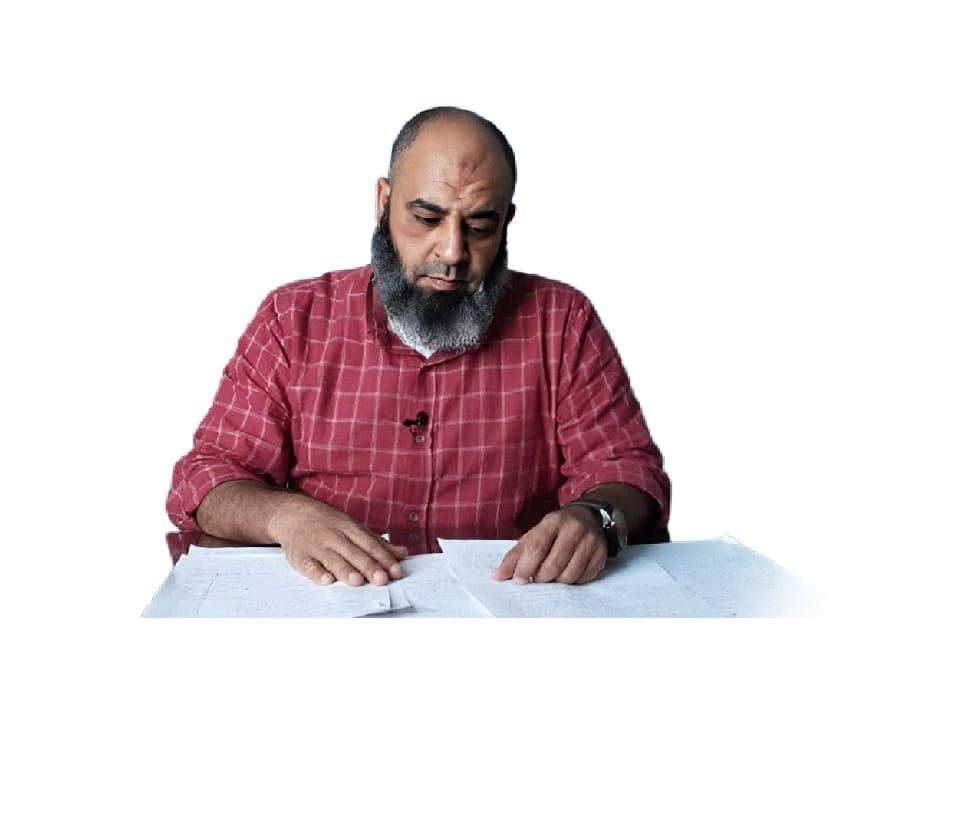
أولًا: تعريف الدولة:
الدولة في اللغة بفتح الدال وضمها هي العُقْبة في المال والحرب سواء، وقيل: الدُّولة، بالضم، في المال، يقال: صار الفيء دُولة بينهم يتداولونه مرة لهذا، ومرة لهذا، والدَّوْلة، بالفتح، في الحرب، بمعنى: أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى، يقال: كانت لنا عليهم الدَّولة، أي: الغلبة، وقيل: هما سواء فيها، يُضمان ويُفتحـان، وقيل: بالضم في الآخرة، وبالفتح في الدنيا، والجمع دُوَل ودِوَل([1]).
-
وجاء في لسان العرب أن الدَّوْلة: الانتقال من حال الشدة إلى الرخاء، فالدولة في اللغة هي حالة من الغلبة والنصر ورخاء الحال([2]).
والدولة اصطلاحًا: هي شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي، تكفل الأمن لنفسها، والرعاية لبنيها ضد الأخطار الخارجية والداخلية([3])، وقد عُرِّفت بتعريفات متعددة، منها: أنها مجموعة دائمة مستقلة من الأفراد يملكون إقليمًا معينًا، وتربطهم رابطة سياسية: هي الاشتراك في الخضوع لسلطة مركزية، وذلك حتى يتمكن كل فرد من التمتع بحريته ومباشرة حقوقه([4]).
والدولة بهذا التعريف: شعب مستقر على إقليم معين، وخاضع لسلطة سياسية معينة. وهذا التعريف يتفق عليه أكثر الفقهاء لأنه يحتوي على العناصر الأساسية التي لا بد لقيام أي دولة منها، وهي: الشعب (السكان) / الإقليم (الأرض) / السلطة (الحكومة) / السيادة([5]).
ثانيًا: أركان الدولة (عناصر الدولة الأساسية):
-
الشعب: حتى تقوم دولة لابد من وجود مجموعة من الأفراد والمواطنين (الشعب) يستقرون على إقليم معين (أرض)، ويرتبطون بالدولة برابط قانوني (الجنسية) & وفي نفس الوقت ينتظمون فيما بينهم وبين بعضهم البعض في مجتمعات ثانوية داخلية (عائلات، قرى، مدن، قبائل، جماعات، …، طوائف دينية، …) ويجمع بينهم الرغبة في العيش المشترك، وبقدر ما يشعر هؤلاء المواطنون (الشعب) بالحاجة إلى التضامن مع بعضهم البعض بقدر ما يقوي تماسك المجتمع الوطني، ولا عبرة في تحديد الشعب بعدد أفراده، فمسألة تعداد الشعب مسألة تقديرية، وكل ما في الأمر أنه يشترط أن يكونوا من الكثرة بحيث يمكنهم التناسل، والمحافظة على أنفسهم، وإدارة شئون دولتهم، وبذلك تستوي الدولة الكثيرة السكان مع الدولة القليلة العدد؛ من حيث التمتع بالشخصية الدولية، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات. كل ما في الأمر أن زيادة عدد السكان تساعد على بسط نفوذ الدولة، وتجعلها مسموعة الكلمة([6]).
-
الإقليم: إقليم الدولة هو ذلك الجزء من الكرة الأرضية الذي تباشر فيه الدولة سلطانها، ويكون مستقرًا لشعبها، ويشمل اليابسة والمياه الإقليمية والطبقات الجوية التي تعلو الأرض والمياه الساحلية، ويتجه الفقه الحديث إلى اعتبار ملكية الدولة على إقليمها حق سيادة، وتُعتبر حدود هذا الإقليم الحد الفاصل بين سيادة الدولة على إقليمها وسيادة غيرها من الدول على الأقاليم المجاورة([7]).
-
السلطة أو السيادة: إن وجود المجتمع يفرض قيام نظام عام قادر على ضبط أوضاعه وتنظيم العلاقات من داخله، وهذا النظام لا ينشأ إلا في ظل سلطة سياسية حاكمة قادرة على إيجاده وصيانته، فالسلطة السياسية هي التي تنظم وتضبط شؤون المجتمع، وبالتالي فلا يمكن للمجتمع أن يستمر بدون سلطة([8]).
وإذا كانت هذه السلطة غير خاضعة لأي سلطة أجنبية فالدولة مستقلة تامة السيادة، تمتلك في الداخل القدرة على القيادة وإجبار الأفراد والجماعات على إطاعتها ولو بالقوة، ولا يمكن لأي دولة أخرى أن تفرض إدارتها عليها، أما إذا كان هناك إشراف من سلطة أجنبية عليها فاستقلال الدولة ناقص غير تام، وإذا كانت هذه السلطة معدومة السيادة تأتمر بأوامر غيرها في الداخل والخارج فلا تكون هناك دولة أصلًا، بل تُسمى في هذه الحالة مُستعمَرة([9]).
(2) مقومات الدولة الإسلامية في دستور المدينة:
بعد استعراض المقومات الأساسية للدولة في الفكر السياسي الحديث، لا نجد صعوبةً في بيان مدى تحقق هذه المقومات في الدولة الإسلامية التي أنشأها النبي ﷺ في المدينة كما يلي:
-
الشعب: أشارت وثيقة المدينة (الدستور) التي اعتمدها النبي ﷺ بعد هجرته مباشرةً إلى خصائص هذه الشعب، وعلاقته بالدولة من ناحية، وعلاقات أفراده ببعضهم من ناحية أخرى، وجاءت بعض مواد الوثيقة لتؤكد على وجود شعب حقيقي متجاوز للعلاقات القَبَلية، كما جاء في المادتين الأولى والثانية([10])، والتي تبين أن المسلمين أمة واحدة، تعلو على العصبيات القبلية، ويرتبط أفرادها برابطة الإسلام، لا رابطة العائلات ولا القبائل، وهو ما حدث بالفعل، حيث اندمج الأوس والخزرج في جماعة الأنصار، ثم انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة المسلمين تحت رابطة العقيدة، وليس الدم، وأصبح ولاؤهم لله تعالى، وانتماؤهم للمجتمع بأسره.



